
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم خلال السنوات الأخيرة، وتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بوتيرة غير مسبوقة، بدأت العديد من القطاعات تتأثر بهذا التقدم بشكل مباشر، بما في ذلك المجالات الدينية والفكرية. وبات من الشائع في بعض الدول والتطبيقات العالمية أن تُطرح تساؤلات حول إمكانية اعتماد الذكاء الاصطناعي في إصدار الفتاوى الدينية، أو تفسير النصوص الشرعية، أو تقديم إجابات فقهية للمستخدمين بناءً على قواعد البيانات الضخمة والبرمجيات الذكية.
هذه الظاهرة المتصاعدة أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الدينية، حيث اختلفت الآراء ما بين مؤيد للتقنيات الحديثة كمجرد وسيلة مساعدة، ومعارض يرى أن الذكاء الاصطناعي لا يملك المقومات التي تؤهله للفتوى في أمور الدين. وفي هذا السياق، خرج الشيخ خالد الجندي – عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية – بتصريح حاسم يؤكد فيه أن الذكاء الاصطناعي "لا يصلح لإصدار الفتاوى"، مؤكدًا أن الفتوى عملية إنسانية وروحية بامتياز، تتطلب وعيًا بشريًا ونزاهة قلبية لا يمكن برمجتها أو تقليدها إلكترونيًا.
هذا التصريح فتح الباب أمام نقاش أعمق حول الفرق بين دور العقل البشري والعقل الاصطناعي في التعامل مع القضايا الدينية، وكيف يجب على المجتمعات الإسلامية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة دون المساس بجوهر الدين ومكانة العلماء ومرجعية المؤسسات الدينية المعتمدة.
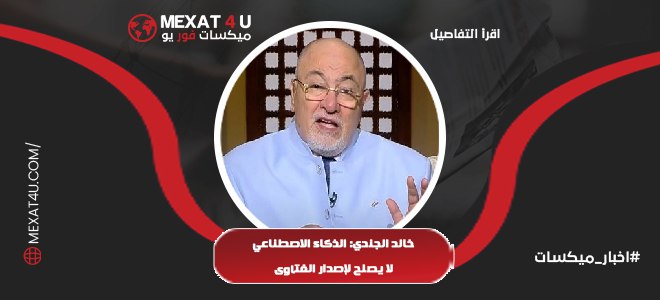
أكد الشيخ خالد الجندي في حديث تلفزيوني أن الذكاء الاصطناعي مهما بلغ من تطور، لا يمكن أن يحل محل المفتي أو العالم الأزهري في إصدار الفتاوى، وذلك لأن الفتوى ليست مجرد عملية استخراج لحكم شرعي من نص، بل هي ممارسة تعتمد على فهم الواقع، مراعاة الظروف، قياس المصالح والمفاسد، التعامل مع النوازل، وتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.
وأشار الجندي إلى أن الفتوى تتطلب ما يُعرف بـ "فقه النفس"، أي فهم حال المستفتي، ومراعاة السياق الاجتماعي والبيئي الذي يعيش فيه، وهي أمور يستحيل على آلة برمجية أن تدركها بالشكل الكامل، حتى وإن تمت برمجتها على ملايين الكتب والمراجع.
وأضاف أن التكنولوجيا يمكن أن تُستخدم كأداة لخدمة الدين، مثل حفظ القرآن الكريم، أو تسهيل الوصول إلى الفتاوى السابقة، أو نشر الوعي الديني، لكن لا ينبغي أن تُمنح سلطة الإفتاء أو تُتخذ كمرجع مستقل عن العلماء والمؤسسات الدينية.
لكي نفهم جوهر تصريحات الجندي، علينا أولًا أن نتطرق إلى طبيعة الفتوى ومكوناتها. فالفتوى ليست مجرد استنباط من نصوص، بل هي عملية مركبة تشمل:
العلم بالنصوص الشرعية (القرآن والسنة والإجماع والقياس).
الإلمام بأصول الفقه وقواعده.
إدراك الواقع الذي ينزل عليه الحكم.
فقه الأولويات وتقديم الأهم على المهم.
مراعاة الظروف النفسية والاجتماعية للمستفتي.
استحضار نية التيسير والتوازن بين النصوص.
وهذه العناصر كلها تتطلب وعيًا إنسانيًا حيًا، وروحًا نابعة من التجربة والعقل، وليست فقط من البرمجة أو الخوارزميات.
وفي ضوء هذا التحليل، يتضح أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يُنظر إليه إلا كـ أداة داعمة للمفتي والعالم، وليس بديلاً عنه. فالمفتي يمكنه استخدام هذه التقنيات لجمع النصوص أو مراجعة السوابق الفقهية أو تصنيف المسائل، لكن القرار النهائي يجب أن يبقى للإنسان، لأن الذكاء الاصطناعي:
لا يملك نية أو ضميرًا.
لا يدرك السياقات المتغيرة للمجتمعات.
لا يستطيع التفرقة بين الفتوى والبيان أو بين العامة والخاصة.
قد يقع في تعميمات خاطئة إذا اعتمد على بيانات غير دقيقة.
ومن هنا جاءت دعوة الجندي إلى الانتباه والحذر عند استخدام هذه التقنيات في المجالات الدينية، وألا تنخدع المجتمعات بواجهة التكنولوجيا وتنسى حقيقة أن الدين مرتبط بالقلوب والعقول، لا بالشيفرات والبرمجيات.
لقي تصريح خالد الجندي تأييدًا واسعًا من قِبل علماء ومشايخ آخرين، حيث أكد كثيرون أن الفتوى تحتاج إلى عنصر "الاجتهاد الشخصي"، وأنه لا يمكن لأي آلة أن تجتهد كما يفعل الإنسان العالم المطلع.
وأشار بعضهم إلى أن هناك بالفعل تجارب في بعض الدول الإسلامية اعتمدت على برامج إلكترونية لتقديم فتاوى تلقائية، ولكنها أثارت كثيرًا من اللغط، ووقع بعضها في فتاوى غير دقيقة أو غير متسقة مع الواقع.
وفي المقابل، يرى البعض أن الذكاء الاصطناعي يمكن استخدامه تحت إشراف العلماء، خاصة في الحالات المتكررة أو التي يوجد لها إجماع فقهي مسبق، مع ضرورة وجود تحذير واضح بأن هذه الإجابات لا تُغني عن مراجعة المفتي.
من الإنصاف أن نقر أن الإسلام لم يكن يومًا منغلقًا على التقدم، بل كان داعمًا لكل ما يسهم في رفعة الإنسان وتقدمه. وقد استفاد المسلمون على مر العصور من التكنولوجيا في خدمة الدين، مثل:
الطباعة والنشر في نشر المصاحف والكتب.
الإذاعة والتلفزيون في نشر الوعظ والخطب.
التطبيقات الذكية في تعليم القرآن والأذكار.
منصات التواصل في نشر الثقافة الإسلامية.
لكن الفرق الجوهري هنا أن هذه الوسائل كانت مكملة للعلماء والدعاة، وليست بديلاً عنهم. وهذا ما شدد عليه خالد الجندي حين أكد أن الذكاء الاصطناعي مجرد وسيلة، ويجب ألا يتحول إلى مرجعية دينية تُتخذ منها الأحكام الشرعية دون إشراف أو وعي.
في معرض حديثه، ضرب الشيخ خالد الجندي مثالًا على ذلك بأن سؤالًا فقهيًا واحدًا قد يُوجَّه إلى مفتيَين مختلفين، وكل منهما يُصدر فتوى مختلفة بحسب فهمه لظروف السائل، وموقعه الجغرافي، ومذهبه، وحالته النفسية، ومستوى علمه. فكيف يمكن لآلة واحدة أن تفهم كل هذه الأبعاد؟
وأضاف أن البعض قد يعتمد على الذكاء الاصطناعي بدعوى السرعة والراحة، لكن الفتوى لا تُختصر بهذه الطريقة، بل يجب أن تمر بمراحل عقلية وروحية ومنهجية.
من جهة أخرى، دعا الجندي إلى ضرورة تنظيم هذا المجال من قِبل المؤسسات الدينية الرسمية، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وذلك عبر:
إنشاء لجان متخصصة تدرس تطور الذكاء الاصطناعي.
وضع ضوابط فقهية لاستخدام التقنية في الفتوى.
التأكيد على أن الإفتاء من الاختصاصات الحصرية للمؤسسات الدينية.
تقديم بدائل تقنية رسمية تخضع لإشراف العلماء المعتمدين.
وذلك لتجنب حالة الفوضى والارتباك التي قد تحدث إذا تُرك الأمر مفتوحًا للتجربة الفردية أو للمبادرات العشوائية من جهات غير مؤهلة.
في ظل تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في كل مناحي الحياة، يظل المجال الديني من أكثر المجالات التي تحتاج إلى تدخل بشري حقيقي، يعتمد على العقل والضمير والاجتهاد. ورغم الترحيب بالتكنولوجيا، فإن الفتوى تبقى شأنًا إنسانيًا بامتياز، لا يليق أن يُوكل إلى آلة لا تشعر ولا تعقل.
تصريح الشيخ خالد الجندي لم يكن رفضًا للتقدم أو إنكارًا للتقنية، بل كان تحذيرًا واعيًا من استخدام غير منضبط قد يؤدي إلى تشويه الفقه الإسلامي وتضليل الناس. ويبقى المطلوب اليوم هو تحقيق التوازن بين استخدام الذكاء الاصطناعي في المساعدة التقنية، والحفاظ على المرجعية الدينية في يد العلماء المؤهلين.
فالدين ليس قواعد جامدة فحسب، بل هو نور وفهم وروح، والذكاء الحقيقي هو الذي يُدرك حدود الآلة ويُبقي للعقل البشري مكانته التي لا تُستبدل.
جميع الحقوق محفوظة 2024 © | MedMarkt